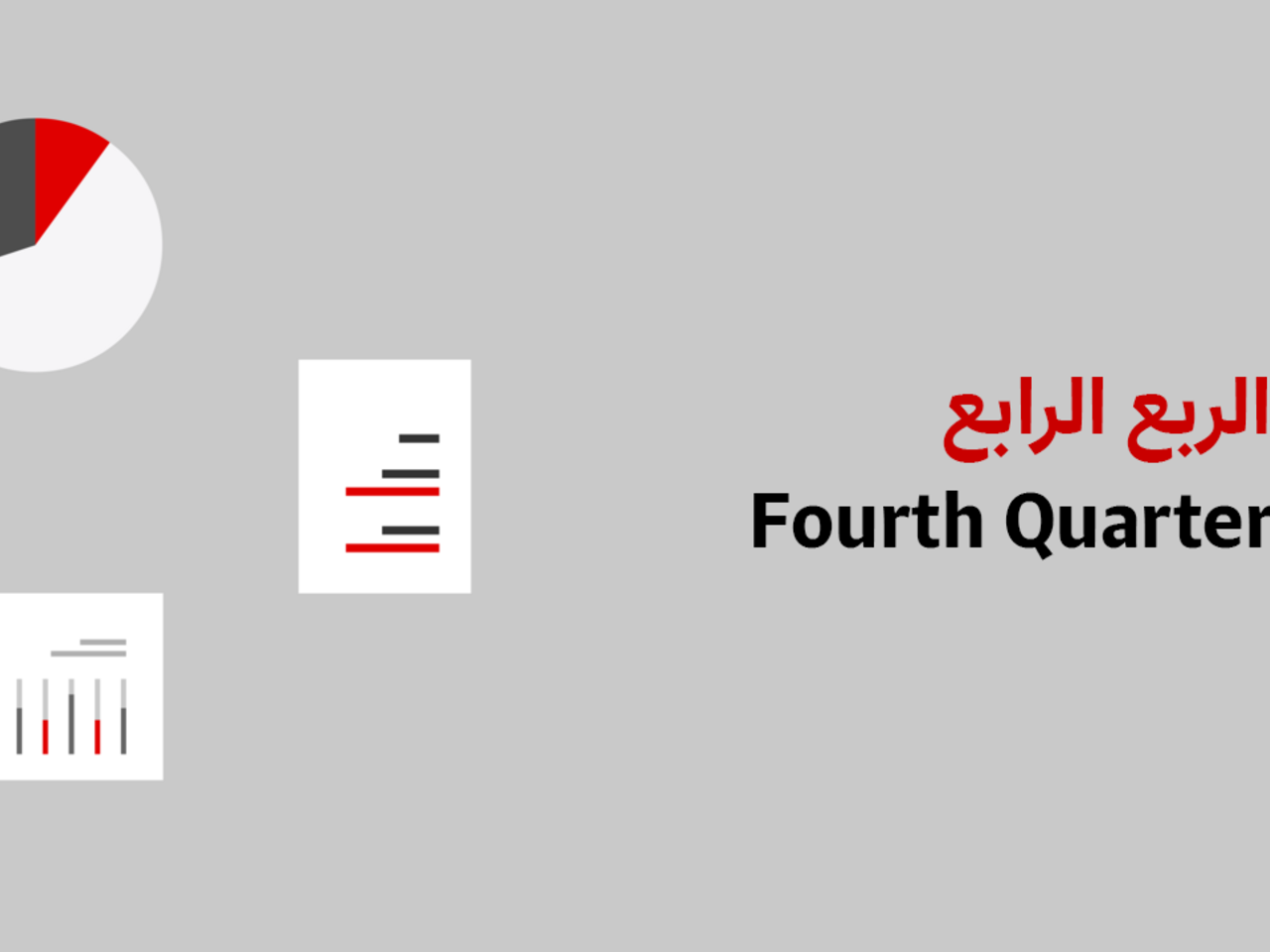المحاكم الدينية تفتّت الأسر والمجتمع
في محاولة لتبرير رفضها إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية، تدّعي السلطات الدينية بأن إقراره يؤدي إلى تفكك الأسرة والمجتمع. لتخفي المحاكم الدينية خلف هذه الذريعة خوفها من إقرار الدولة قانون أحوال شخصية يحقق العدالة والمساواة، فيرفع سلطتها عن حياة الناس ويؤدي لتراجع نفوذها وسطوتها على علاقة الناس فيما بينهم.
وعلى العكس من ادعاءات السلطات الدينية غير المصحوبة بأدلة، تثبت التجارب أن قوانين الأحوال الشخصية الطائفية هي التي تفتت الأسرة والمجتمع وتفرق الناس. إذ تنظر السلطات الدينية إلى الأسرة ككيان في خدمة مصالحها، يرأسه الرجل ويملك السلطة عليه. وتصدر المحاكم الدينية الأحكام الجامدة التي تغذّي سلطتها بدل تلك التي تخدم كافة أفراد الأسرة وتلبي احتياجاتهم التي اختلفت مع تطور المجتمع. ولا تراقب محاكم الطوائف كيفية ممارسة من تسميه "رب الأسرة" للسلطة التي منحته إياها، بل تضمن حمايته حين يحولها لتسلط، حتى أنها هي التي تحثّه عليه. ما يسبب اضطرابات في العديد من الأسر.
وعن سابق تصميم، يحرص نظام الأحوال الشخصية الطائفية على منع المواطنين من عيش مواطنتهم. إذ يربيهم على التعصّب والطائفية، ويعزز تقسيم المجتمع بدل تنظيم حياة أبنائه. فتؤدي المحاكم الدينية دورها في محاربة أي خطوة تساهم في دمج المواطنين من مختلف الطوائف في بيئة جامعة، وتتعمد زارعة التفرقة بينهم، مقنعة إياهم باستحالة الأمر، ومحذرة من عاقبته في الدنيا والآخرة . بذلك تضغط هذه المحاكم على المواطنات والمواطنين وتدفعهم للتنازل عن أبسط حقوقهم، أهمها الحق بالمساواة الذي كفله الدستور والذي يشكل أحد أهم أسس المواطنة.
بممارساتها هذه تخلّ محاكم الطوائف بالنّظام العام والمصلحة العامة لصالح المؤسسات الدينية. ما يتناقض مع المادة التاسعة من الدستور، نفسها التي كفلت حرية إقامة الشعائر الدينية شرط عدم الإخلال بالنظام العام. وليست هذه المؤسسات بمعزل عن نفوذ رجال السياسة، إنما تصبّ أفعالها في خدمتهم، إذ تحافظ على بنية النظام الطائفي القاتل. ما يدفع بالمشرّع اللبناني للإختباء خلف رجال الدين والتنازل لهم عن مهمته التشريعية، لدى مطالبته بإقرار قوانين تعاقب على الجرائم التي تبيحها وترتكبها المؤسسات الدينية، مثل تزويج الطفلات والاغتصاب الزوجي وغيرها.
من هنا تظهر مصلحة رجال الدين والسياسة في الإبقاء على قوانين الأحوال الشخصية الطائفية التي لا تواكب تغير المجتمع ولا تؤمن حقوق واحتياجات أفراده. فيستشرسون في محاربة كل من يطالب بإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية، يمنح كل فرد في المجتمع حقه ويلبي احتياجاته، إن على صعيد العائلة وإن على صعيد الوطن ككل.
فاقتراح القانون الموحد للأحوال الشخصية، والذي اقترحته منظمة "كفى"، وضع وفق أسس علمية، بعد دراسة حاجات المجتمع وأفراده وتجاربهم السيئة مع المحاكم الدينية. ويهدف القانون المقترح لتحقيق صالح جميع أفراد الأسرة والمجتمع، بمن فيهم الأب، ما يصبّ في الصالح العام.
ويؤدي القانون الموحد للأحوال الشخصية، قانون الدولة لا الطوائف، لضمان عدم استقواء فرد من الأسرة على الآخر. على العكس مما هي الحال مع القوانين الطائفية التي تحولت لأداة إخضاع وانتقام بيد الرجل ضد زوجته وبقية أفراد أسرته. ما يسبّب نشوء الخلافات في الأسرة، نتيجة عدم التوازن في توزيع السّلطة والمسؤوليات. خصوصاً وأنّ هذه القوانين لا تحمي المرأة والأطفال من العنف الأسري، بل تجبر الزوجة على الخضوع لأوامر الزوج تحت طائلة أن تصبح "ناشز". هي سلطة تدفع الزوجين نحو خيار الانفصال بأسوأ الطرق، والتي تغذي مشاعر الحقد والرغبة بالانتقام لدى الطرفين، ما ينعكس على الأطفال.
ولا تؤدي هذه الممارسات إلى تدمير الأسرة في الحاضر فحسب. فهي وبعد سحق الأطفال الذين لا تراعى مصالحهم ولا يعار كيانهم أي اهتمام، تؤثّر في نفوسهم على المدى البعيد. فيعجز الكثير من هؤلاء فيما بعد عن الارتباط وإنشاء عائلة وتحمل المسؤولية.
ومهما كابر رجال الدين والسلطة، فالحلّ واضح ويدركونه جيداً. وهو إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية يراعي حاجات الجميع. إذ يردع القانون الموحد الموضوع على أسس سليمة الرّجل، ويمنعه من ممارسة التسلط والانتقام، ما يخفف من المشاكل داخل الأسرة. ويتيح قانون الدولة للزوجين الانفصال بودّ أو وفق تسويات واضحة تراعي حاجة الأطفال. ما يؤدي لاستمرار علاقة متوازنة بين أفراد الأسرة حتى بعد انفصال الوالدين، وسيضمن لهما القانون البقاء مع أطفالهما بما يلبي حاجة هؤلاء الأطفال. بالإضافة لذلك، يفرض القانون الموحد سيادة الدولة على أراضيها، ويوحد المواطنين من مختلف الملل تحت قانون يساوي بينهم ويعزز انتماءهم الوطني. بذلك تتحقق اللحمة بين مختلف فئات المجتمع من دون أن يمسّ بإيمانها.
منظمة "كفى"
بقلم الصحافيّة "مريم سيف الدين"